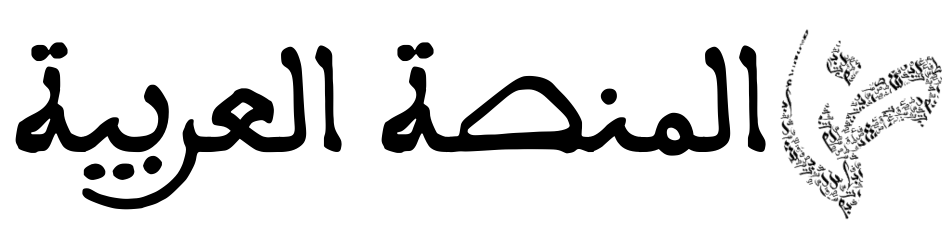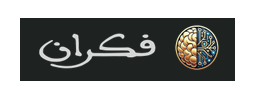لقد راعنا وحرَّك وِجْداننا ما آلت إليه لُغتنا، وما أصابَها من هزَّة تُهَدِّدها بالانهيار والتمزُّق، أو إزاحتها عن مَملكتها، وإحلال أنْماط أخرى من الكلام مَحلَّها، تعتلي عرشها في صَلَفٍ وتبجُّح، أو يُدْفَع بها دفعًا إلى هذا العَرْش بأيدٍ غير واعية وَسْطَ جلجلةِ أصوات نافرة، زاعقة بأحقيَّة هذه الأنْماط من الكلام لاعتلاء هذا العرش، والسَّيطرة على مقدرات الجماهير.
هذه هي حال عربيَّة العرب الآن (الفصحى أو الفصيحة)، وحال أهلها أو نَفَرٍ غير قليل منهم إزاءَ هذا الصِّراع، وتنازع المواقع لكلِّ مستوًى من مستويات الكلام، فصيحًا كان أم عاميَّاتٍ أم رطانات تملأُ الساحة بالهياج، ورفع العقائر؛ تخويفًا وترهيبًا؛ لِمَا حَظِيَت به هذه العاميات والرطانات من فوضى الكلام، وتَسرُّب تنوُّعاته هنا وهناك، حتى خُيِّل لها أو لرافعي لوائها أنَّها سيطرت على سوق الكلام بأجمعه، فصارت صاحبةَ اليد العُليا، تشير فتُطاع وتُصرِّف شؤون الناس، فيستجيبون طَوعًا أو كَرهًا.
هذه العاميَّات والرَّطانات تطير في الجوِّ العربِيِّ، وتملؤه بغبارِ المتنافرات المنشورة من صُور الكلام، وتُحاول تعتيمَ المساحة الضيِّقة الصافية التي ما زالت (عربيَّة العرب) تتمسَّك بأهدابها في جهد جهيد، وتستصرخ أهلها المنسوبة إليهم؛ ليفسحوا لها مجالاً أوسعَ وأرحب؛ حتَّى تستطيع أن تزيحَ هذه العتمة أو تضيِّق دائرتَها، فتسطح الشَّمسُ، ويُصيبُ ضوءُها السائرين في فيالق الكلام.
حقيقةً، إنَّ العربيةَ الفُصحى مَحشورةٌ في موقع ضيِّق، وَسْطَ زحام الجموع المتنافرة من أنماطِ الكلام، المتفاخرة بالكَثْرة وغلبة العدد، غَيْرَ مُدركَةٍ أن الزَّاحفين بها نَحْوَ ساحة المعركة اللُّغوية جُمُوعٌ هَشَّة، لا تلبث أنْ يتساقطَ أفرادُها في الطريق؛ لفقدانِها سلاحَ الانتصار وعدته، كانت هذه هي الكلمة التي قدم بها د./ كمال بشر كتابَه الثَّريَّ “اللغة العربية بين الوَهْم وسوء الفهم“، والذي صدر عن دار غريب.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان سوس تؤكد عروبة المغاربةوعلى الرَّغم من ذلك، فما زال نفرٌ من غير العارفين يصرخون بالهتافات المحمومة؛ تشجيعًا لفيالق الكلام من العامِّيَّات والرَّطانات، وشدًّا لأزرها؛ حتَّى تسيطر على أرض العرب، فيخضعون لها، ويُوَلُّون وجوهَهم شطرَها، متنكِّرين لعربيَّتهم، أو ملقين بها عُرْضَ الحائط، وشَمَّر هؤلاء عن سواعدهم، واعتَلَوْا أعوادَ المنابر يدعون وينصحون، ويقدمون أدلَّتهم وبراهينهم الواهية على أحقِّيَّة هذه الأنماط من الكلام؛ للاستحواذ على الأرض العربيَّة من أقصاها إلى أقصاها، إنَّها في نظرهم أوسعُ انتشارًا، وأقرب منالاً، وأسهل استيعابًا، وأوفى بحاجات النَّاس ورغباتِهم في التَّواصُل وتدبير شؤونِهم، إنَّها معهم أينما حَلُّوا، وأينما ارتَحلوا، في حين أنَّ الفُصحى الفصيحة قد نأتْ بها الدِّيار، وتخلَّت عن الزَّحف في المسير؛ لضعف أجنادها، وهُزال أسلحتها، فَقَدِمَتْ بِرُكنها الضيِّق الذي لا يعرفه، ولا يركَن إليه إلا فئة أو فئات من الأقوام محدودة، مشدودةً بطبيعتها إلى العُزلة والانحياز إلى التقاليد الموروثة التي عَفا عليها الزَّمنُ، وذهب بفاعليتها أدراجَ الحياة.
هكذا قَدروا “العربية”، ونعتوها بالجمود والانحسار، وجَهدوا أنفسَهم في تقديم أدلَّتِهم على أوهامهم تلك، ناسين أنَّ العربية الفُصحى لم تأنسْ إلى هذا الرُّكن الضيق، وإنَّما دُفع بها دفعًا إليه بصنع أهليها، وتضييق الخناق عليها وسدِّ منافذ الحركة أمامها.
من هنا جاء طرحُ هذه القضية على صفحات هذا الكتاب الذي يتكوَّن من بابين، إضافةً إلى الخاتمة، وقد جاء الأوَّل تحت عنوان “الواقع المعاصر للغة العربيَّة وموقف الناس من هذا الواقع”.وينقسم البابُ الأوَّل ثلاثةَ فصولٍ.
إقرأ أيضا:التعلم العميق: ماهي الشبكات العصبية الاصطناعيةيتناول الأوَّل الواقعَ المعاصر للغة العربية، وقد جاء فيه أنَّ لغتنا القومية مضطربة اضطراب أهليها فكريًّا وعلميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، فالفصحى – وهي لغة العرب – محشورة في رُكن ضيِّق من الساحة اللُّغوية، وعاميات ذات لهجات ورطانات تسيطر على الجوِّ العام، أو خليط من هذا وذاك.
وزاد الأمرَ سوءًا انصرافُ الناس عن فُصحاهم، والميل إلى التغريب اللغوي في صورة عَزْلها عن بعض المواقع العلميَّة، واتِّساع دائرة اللغات الأجنبية مُمثلة في مدارس اللُّغات وغيرها.
وكان طبيعيًّا أن يحار الناس إزاء الوضع المضطرب، فتفرقوا شيعًا وأحزابًا، لكلٍّ منها وجهة نظر (صائبة أو خائبة) تدعو إلى الأخذ بهذا المستوى أو ذاك، ولم ينتهِ أيٌّ من الفُرَقَاءِ إلى رَأْيٍ حاسم أو خطٍّ واضح، ويُخلِّصُنا من هذا التلوث اللغوي.
أمَّا الفصل الثاني للباب الأول، فقد جاء تحت عنوان “المشكلة اللغوية بين الوَهم وسوء الفهم”، وفيه يكشف المؤلف عن بعضِ الأوهام الدَّاعية إلى الانصراف عن الفُصحى والانحياز إلى العاميات، وتلك التي تدعو إلى توزيع هذه اللغة توزيعًا جغرافيًّا أو زمنيًّا، فقد رأى قوم أن العربية الآن عربيَّات لا عربية واحدة، فهناك في رأيهم العربيَّة المصرية، والعربية السعودية والعربية الشامية… إلخ.
وهناك أيضًا عربية العصر الجاهلي، وعربية صدر الإسلام، وعربية العصر الأموي، حتى وصلوا إلى ما سمَّوه (العربية المعاصرة)، فكل هذه العربيات صالح لبيئته، أو كان صالحًا لفترته الزَّمنية، وأدَّى دوره في سياق زَمَنِه، فليقنع كلُّ قطر عربي بعربيته، ولنتمسَّك الآن – إنْ أردنا الإصلاحَ – بالعربية المعاصرة، فهي أوثق صِلَةً بالناس، وأوفى بحاجاتِهم التعبيريَّة في العصر الذي نعيش فيه، وقد نَسِيَ هؤلاء أنَّ هذا التوزيع الجغرافي وقبيله الزَّمني من شأنهما تمزيق العربية، وقطع أوصالها، وربَّما يؤدي الأخذ بهذا النَّهج أو ذاك إلى الوصول بنا إلى عاميَّات ورَطَانات تفرِّق الفكر العربي، وتُشتِّت وحدته، وتبقى المشكلة على حالها، ونعيشُ في حلقة مفرغة لا يُدرى طرفاها.
إقرأ أيضا:الحايك العربي المغربيورأى فريق آخر اعتمادَ لُغةِ المثقفين لغةً عامة؛ إذ إنَّها تنتظم عناصر لغوية ترشِّحها للقبول من الجماهير العريضة، وقد فشلوا في تحديد مفهوم هذه اللُّغة وبيان خواصِّها التي تُميزها عن غيرها من المستويات، كما لم يُوفَّق القائلون بأخذ اللغة المكتوبة نموذجًا للإصلاح اللغوي، ولم يدركوا أنَّ اللغة لا تُكتسَب من المكتوب وحْدَه، وإنَّما الأساس في ذلك هو الاكتساب عن طريق النُّطق الفعلي، فاللغة اصطلاحًا هي اللغةُ المنطوقة، في حين أنَّ اللغة المكتوبة ليست إلا مجرد تصوير للمنطوقة.
إنَّ كلَّ هذه المقترحات أوهام ناتجة عن سوء الفَهم للمشكلات الحقيقيَّة للعربية التي ينبغي النظر فيها، والعمل على إزاحتها؛ حتَّى تبقى لنا لغةً موحدة أو شبه موحدة، على غرار ما تفعله وتسلكه الأمم المتحضِّرة.
ويأتي الفصل الثَّالث للباب الأول تحت عنوان “اللغة بين الطبع والصُّنع”، فقد اختلف الدارسون في حقيقة اللغة وطبيعتها، أهي عقلية – أي: التعبير عن الأفكار – أم هي ظاهرة اجتماعية وظيفتها التوصيل والتواصل؟ وقرَّرنا أنَّ للجانبين وجودًا وأثرًا، وأنَّ اللغة تمر بدورة من مراحل ثلاث، هي الطَّاقة أو القُدرة أو الخليقة، ثم تفعيل هذه الطاقة وقُدرتها على الإنتاج، وهذه هي السليقة، ثم الإنتاج نفسه المتمثل في المنطوق الحي، وهذا المنطوق أسبقُ وأوفى نصيبًا في تشكيل اللغة وبنائها، فالإنسانُ يسمع فتنطبع في ذهنه آثارُ ما سمع، ويتطبع من هذا المخزون فيخرج وفقًا لهذا المخزون، إنْ كان المخزون فصيحًا كان المولد كذلك، وإن كان عاميًّا جاء المنطوق على مثاله.
ومن هنا كان لا بُدَّ لنا – إن أردنا الإصلاح – أن نركز على المنطوق، ومعناه أنَّ اللغة في جُملتها من صُنع الإنسان، وتعتمد في ذلك على مَنْهجه وسلوكه في هذا الصنع.
ويَجيء الباب الثاني تحت عنوان: “من مشكلات اللغة العربية”، ويتكوَّن من فصلَيْن هما: مشكلات قديمة، وبه مبحثان: الأوَّل: جاء بعنوان: “تقعيد اللغة ومناهجه”، فقد برع العرب القُدامى في تقعيد لُغتهم وضبط أحكامها، وصولاً إلى بنية صالحة للأخذ بها، والسير على مثالها، واعتمدوا في الأساس على المنهج المعياري، ولكنَّهم في وسط الطريق كانوا يلجؤون إلى مناهج فرعية أخرى؛ لصُعُوبة تطبيق هذا المنهج في كلِّ الأحوال، عائدًا إلى النظر المنطقي والفلسفي وإلى التأويل والافتراض… إلخ.
ومن ثَمَّ وضع شيءٍ من الاضطراب في نَتائجهم التي استقرَّت حتى اليوم، هذا إضافةً إلى أن هؤلاء الأجداد قصروا التقعيدَ على فترة زمنية محددة، الأمر الذي فوَّت عليهم وعلينا أنْ ينظروا بِجِدٍّ في اللغة العربية من مظاهر التطوُّر والتجديد في أثوابها المتغيرة، وَفْقًا لمتغيراتِ الحياة وظروفها، وكانت النَّتيجة ظهورَ بعض الصُّعوبات في استيعاب قواعد العربية كما رسمها الأجداد، فانطلقت بعضُ الأصوات تنادي حديثًا بتيسير هذه القواعد أو تهذيبها وصقلها.
وركَّزوا على جانب واحد من جوانب هذه القواعد، وهو النَّحو؛ ولكنَّ أصحابَ هذه الحركة الإصلاحيَّة لم يدركوا أنَّ قواعدَ النحو إنْ هي إلاَّ جانبٌ واحد من جوانب قواعد اللغة بمعناها الدَّقيق، هذا إضافةً إلى أنَّ إصلاحَهم لقواعد النَّحو جاء مشوبًا بشيء من القُصُور، وعدم الرُّؤية الصحيحة لخطوط الإصلاح الحقيقي لهذا الجانب من جوانب اللغة؛ ولذلك رأينا أن تكون هناك نظرة تاريخيَّة دقيقة تقوم على الدِّراسة باتِّباع الخطوات التالية:
• تتبُّع الظواهر اللغوية من فترة زمنيَّة إلى أخرى، بطريق الحَصْر والاستقصاء لكلِّ ما بدا ويبدو من فروقٍ واختلافات على المستويات اللُّغوية.
• لا يتم هذا التتبُّع ولا يكون صحيحًا إلاَّ بعد القيام بدراسة وصفيَّة لكلِّ فترة على حِدَة؛ حتى يتمكن الدَّارس التاريخي من تعرُّف طبيعة كل فترة وخواصِّها المميزة لها، منتقلاً إلى ما بعدها من فترات.
• تعيين الظَّواهر الفارقة لكلِّ فترة منسوبة إلى مستواها اللغوي، صوتيًّا وصرفيًّا، وتركيبيًّا ودلاليًّا.
• تجميع هذه الظواهر الفارقة وتصنيفها إلى وجوهها المختلفة، ثم النَّظر إليها وفيها بنظرة علمية موضوعية؛ لبيان مدى الاتِّفاق والافتراق هنا وهناك.
هذا هو النِّظام اللغوي العام الذي لا بُدَّ من النظر فيه ودراسته دراسة علمية دقيقة؛ حتى يتبيَّن لنا وجه الحق في هذه القضية، والسُّؤال: هل وَقَع شيء من هذا الدَّرس التاريخي للغتنا؟
الإجابة بالنفي بكلِّ قوة وحَسْم، ولا يُعترَض علينا بما قام به بعضُ اللُّغويين المحدثين من النَّظر في هذه النُّظُم، فقد انصرفَ نفرٌ منهم إلى دراسة النِّظام الصَّوتي، ولم تكن الدِّراسة تاريخية، وإنَّما كانت وصفية، وكان هذا النظر الصَّوتي لتطبيق قواعدِ العمل اللغوي الحديث على هذا الجانب أُسوةً بما وقع للغات أخرى، ووفاءً بحاجة النَّاشئة من الدَّارسين إلى تعرُّف هذا النظام الذي لم يولِه القُدامى اهتمامًا كافيًا.
أمَّا النظامان: النِّظام النحوي، والصَّرفي للغتنا، فلم تنلهما حُظوة النَّظر الحديث فيها بطريقة علميَّة، لا من الناحية التاريخيَّة أو الوصفية، فقد عَرَضَ بعضُ المحدثين لقضايا صرفيَّة، وحاولوا تحليلَ مادَّتِها تحليلاً جديدًا بقصد التيسير والتسهيل على الدَّارسين، بمحاولة تصنيف هذه المادة تصنيفًا أقرب مثالاً واستيعابًا مما فعله الأقدمون.
أمَّا النظام النحوي (أو علم التَّراكيب)، فكان حَظُّه من المنافسة والجدل ووجوب النَّظر فيه حظًّا موفورًا انصرفَ إليه الكثيرون، وحاولوا على فتراتِ الزمن المختلفة أنْ يضيفوا شيئًا فيه؛ بغية الوصول إلى نوع من بناء نحوي جديد.
أمَّا الفصل الثاني من الباب الثاني، فجاء تحت عنوان: “مشكلات حديثة”، ويقع في أربعة مباحث.
الأول:النظرة الاجتماعية والنَّزعة إلى التغريب:
لقد انصرفت الجماهير العربيَّة عن لُغتهم، وقنعوا بما ألفوه من عاميَّات ذات لهجات ورطانات مُختلفة، ولم يُفكِّروا في مُشكلات هذه اللغة، إمَّا لأنَّهم انشغلوا بأمور حياتهم المتشابكة، ولم يجدوا قدوة أو أصواتًا مُخلصة تأخذ بيدِهم نحو الطريق السَّوي، وإمَّا توهُّمًا بأن العربية أصبحت عصيَّة المنال، بعيدة عن التطويع ومقابلة حاجتهم الآنيَّة؛ لذلك عزلوها، وأقاموا جدارًا من الجفاء بينها وبينهم، وقد مال بعضُهم إلى التغريب اللُّغوي والثقافي، وظهر هذا التغريب – حشو الكلام بعبارات أجنبية – في الشارع ودور التعليم والفنادق والمؤسسات العامَّة والخاصة.
ويتناول المبحثُ الثاني سيطرةَ العاميات على السُّوق اللغوية العربية؛ مما يُهدد الفصحى بالخطر، ولمعالجة هذا الأمر المغلوط ظهرت أربعة اتِّجاهات:
الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن من طبيعة اللغة التنوُّع، والتوزيع إلى عاميات، والتي تقوم بدورها في التواصل والتوصيل.
الاتجاه الثاني: نادى به جماعة من المخلصين رأوا أن لا مناصَ لنا إلاَّ التمسُّك بالفصحى، كما ورثناها عن الأجداد، والعمل على نشرها، والأخذ بها دائمًا وأبدًا.
أمَّا الاتجاه الثَّالث: فقد نادى أصحابُه بما سَمَّوه اللغة الثالثة التي تنتظم عناصر من الفصيح، وأخرى من العاميات، ولكن هذه الدَّعوة لم تنجح، ولم يكتب لها البقاء، وقد تفرع عن هذا الاتجاه رأيٌ يرى أنَّه يُمكن اعتماد لغة المثقفين لغة عامَّة، ونسوا أن هذه اللُّغة ما زالت تمثل ضربًا من الخلط بين المستويات اللغوية.
أما الاتجاه الرابع: فهو أخطرها وأبعدها أثرًا على العربية، فقد ظهرت دعوة قديمة حديثة تدعو إلى الأخذ بالعاميَّات ونبذ الفصحى نهائيًّا؛ لأنَّها لم تَعُدْ ذات غناء في التوصيل والتواصل لجماهير الشَّعب العربي.
وهكذا اتَّضح لنا الخلط في الرُّؤية والتجاوز في الاتجاه نحو علاج المشكلة اللغوية، فكل ما اقتُرح من مستويات لغوية نادى أصحابها بصلاحيَّتِها وضرورة الأخذ بها – لا تؤهل نفسَها بواقعها الحاضر لأَنْ تكونَ نقطةَ الانطلاق إلى الإصلاح اللُّغوي، فالأخذ بالعامِّيَّات عَوْدٌ إلى (الشعوبيَّة) التي قاسيناها في فتراتٍ معينة من الزَّمن، وانزاحت من الساحة العربية إلى غير رجعة، والقول بعمومية (الفَصَاحَات) وشُمُولها قول مُضلل، فكلُّ مستوًى فصيحٍ في حدود ضيقة مقصورة على فئة من الناس دون أخرى، ولكنَّ الفصاحة العربيَّة واحدة، وليست مَثْنى أو ثلاث أو رُباع… إلخ.
الفصاحة العربية تعني – علميًّا وقوميًّا – مستوًى واحدًا من الكلام يَجمع العرب جميعًا على كلمة سواء.
ويأتي المبحث الثالث تحت عنوان: “العربية في دُور التعليم”، ويفيد أنَّ العربية في دُور التعليم في وضع يدعو إلى القلق، بل الانزعاج، فالجوُّ اللغوي العام هناك ما يزال مشحونًا بأخلاط الكلام ونَوافِرِه من عاميَّات ورطانات في الأفنية والفصول والمدرَّجات أحيانًا، مع توظيف قليل للعربية الفصيحة، وهو توظيف مغلوط في أحيانٍ غير قليلة، فالأساتذة في الكليات والجامعات يتكلَّمون عن اللغة ومشكلاتها وفلسفة قواعدها… إلخ، ولا ينصرفون إلى مهارات اكتساب اللغة إلاَّ بطريق المصادفة في أوقات محدودة.
وهكذا يخرج معلم العربية من الكليات أو الأقسام المتخصصة خالِيَ الوِفَاض من بضاعته الأصليَّة، فنشكو من ضَعْفه ومن صُعُوبة العربية، فنشكو المعلم، ونندب حاله، الذي يحتاج إلى النظر والعلاج.
تفتَّقت أذهان بعضهم عن بدعة إنشاء “كليات التربية”، وهي كلية تجمع بين شقين من المواد: “مواد التخصص، ومواد الإعداد الفني”، ولاحظنا أنَّ اهتمام الطالب ووقتَه ينصرفان إلى مواد التربية وما لَفَّ لفَّها، وكانت النتيجةُ ضعفًا ملحوظًا في مواد التخصُّص وهي العربية، ورأينا أنَّ الحل هو الفصل بين الجانبين، فالتخصص في الكليات المتخصصة، والإعداد الفني في كليات أو معاهد التربية.
ويختتم هذا الباب بالمبحث الرابع، وهو بعنوان: “اللغة العربية لغير العرب”.
في السنوات الأخيرة كان هناك إقبالٌ شديدٌ في الداخل والخارج على تعلُّم العربية، لكن الراغبين في التعلُّم صُدِموا؛ لأنَّ العربية أصبحت ذات مستويات مختلفة.
وهناك جهود قدمت لمحاولة الوفاء برغبات هؤلاء في الأغلب، والمفروض أنْ يُحاول العرب القيام بإعداد خطة لتعليم العربية تفي بحاجات الرَّاغبين في تعلُّمها، آخذين الفصحى أساسًا للعمل، مع مراعاة حاجات الطوائف المختلفة، مع كلِّ الحالات ينبغي عند وضع الخطة أنْ تُراعى أمورٌ مُهمَّة، منها: تحديد مستوى المادة التي تقدَّم، مراعاة اختلاف الدَّارسين ثقافيًّا وجغرافيًّا، ومراعاة التدرُّج في تقديم المادة من القديم إلى الحديث، ونوصي أيضًا بمراعاة اختلاف الدارسين في أعمارهم.
وعند تقديم المادة لهؤلاء الدَّارسين ينبغي أن يقومَ بها معلمون أكْفَاء ذوو دِرَاية بتعليم اللغة لغير أهلها، آخذين في الحسبان المهارات الأربع في تعلُّم أيَّة لغة، وهي: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والحديث، فهذه مهارات مُتَّصل بعضها ببعض، ولا ينبغي الفصل بينها.
نخلص مما تقدم:
نحن أمَّة واحدة، إذًا بهذا المفهوم الذي نزعم اتِّفاقَ النَّاس عليه، ومُطابقته للواقع في الماضي والحاضر، والمعروف أنَّ كلَّ أمَّة تسعى جاهدةً إلى أن يكونَ لها لسانٌ واحد، أو مستوى لغوي موحَّد أو شبه موحد، من شأنه أن يَجمع النَّوافر من الأفكار والمتنابذات من الاتِّجاهات والأنماط السلوكية الثقافية والاجتماعيَّة، ويُشكل من هذه الأمة بيئةً قومية متماسكة الأطراف، تماسكَ هذه اللغة الموحدة التي يَجهد أصحابُها في تثبيت أركانها ودعم قواعدها؛ لذلك لا بُدَّ من الكشف عن الأسباب التي تؤدِّي إلى مشكلات اللغة العربية، وتستخلص في الآتي:
• اللغة العربية (لغة العرب) في وضع يسودُه الاضطراب والخلط بين فصيح صحيح، وعاميَّات ورطانات ذات أشكال وألوان.
• ينظر الناس إلى هذا الوضع نظرًا متباينًا، فمنهم من انحاز للعربية دون تحديد دقيق للمفهوم.
• وهم القائلون بالعاميات أو بالخلط بين المستويات، فاتَّهموا العربيَّة بالجمود والتخلُّف.
• لكن هذا وهم ناتج عن سوء فهم، فاللغة لا تجمد ولا تتخلف بنفسها، وإنَّما يرجع ذلك إلى ذويها.
• والسبب منهج التقعيد في القديم، ولأَنصاف المثقفين دَوْرٌ بارز في ذلك؛ لبُعدهم عن استيعاب قواعد اللغة وتوظيفها توظيفًا حيًّا فاعلاً.
• أما في الحديث، فاللغة العربية غَرِقَت في بحر من المُشكلات التي كادت تذهب بها، وتُحيلها أثرًا بعد عَيْن، ومن أهم هذه المشكلات: النَّظرة الاجتماعية إلى اللغة، التي لا تعدل قَدْرَها وأهميتها وعَزْلها عن مواقعها الطبيعيَّة.
وقد وضع الدكتور الباحث/ كمال بشر حلولاً لهذه المشكلات، من أهمها:
• ينبغي العودة إلى هذه اللغة نفسها لمراجعة مشكلاتها الموروثة والطارئة عليها.
والجدير بالذِّكر أنَّ لدينا أرضًا وبنية قوية صالحة لأَنْ تكون أساسًا للوحدة اللغوية، أو تجميع الشتات من أنْماط الكلام، وصقله ولملمة أطرافه؛ حتى يظهر الكلُّ في قالب واحد، مندرسين إلى صيغة لغوية بناؤها ثابت، طلاؤها مُتجدد، فعربيَّتنا الفصحى وامتدادها الفصيح ينبغي أن تكونَ نقطةَ الانطلاق نحو علاج مشكلتنا اللغوية، فالفصحى هي أساس العمل وبداية المسيرة.
فلا بد إذًا من القيام بتخطيط لغوي واضح المعالم والحدود؛ بغرض الوصول إلى وحدة لغوية.
نقول ذلك استنادًا إلى عاملين أو مَيْزَتَيْن تَمتاز بهما الفصحى من غيرها من اللُّسُن واللهجات والرطانات:
أولها: أن الفصحى لسان موحد، وهي السبيل لتوحيد البنيتين: الفكرية والثقافية.
والميزة الثانية: أنَّ الفصحى هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، والموروث العربي الإسلامي، وهي الرابطة الحقيقيَّة التي تربط الحاضر بالماضي.
وتشكل تاريخًا متكاملاً ذا أساس متين، هذا إضافةً إلى أن الفصحى غنية بثَرْوتِها اللفظيَّة وتنوع أساليبها التعبيرية، الأمرُ الذي سهل على كل المتعاملين بها توظيفها في كل مجالات الحياة بلا فرق.
إن المناداةَ بالفصحى لغة تواصل عام كَتْبًا ونُطقًا في العالم العربي مبدأٌ راشد، نؤيده منطلقًا لإصلاح لغويٍّ يتبعه حتمًا إصلاحٌ ثقافي اجتماعي علمي.
المصدر: شبكة الألوكة، لكاتبه مديحة أبو زيد.